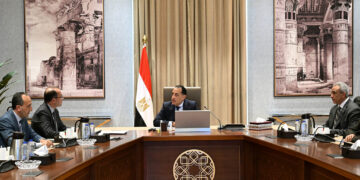“رؤية 2030” تحاول الحد من اعتماد البلاد على صادرات البترول
عادة ما يتحدد التحول الاقتصادي من خلال التغيير السريع والجذري الذي يمكن أن يكون منظمًا ومتعمدًا، كالذي شهدته المملكة المتحدة خلال أوائل الثمانينيات، أو غير مخطط له وفوضوي، كالذي حدث في أوروبا الشرقية بعد سقوط جدار برلين، لكن التحول الاقتصادي الكبير القادم في العالم، يجري الآن في السعودية.
تضمنت كثير من التحولات الاقتصادية الماضية قدرًا كبيرًا من الاضطرابات الاجتماعية، وتسببت في عواقب غير مقصودة وأضرارًا جانبية يتحملها في الغالب أولئك الذين ازدهروا في ظل الوضع الراهن السابق.
في المملكة المتحدة، مثلاً، شهدت النقابات العمالية اضطرابات وأعيدت هيكلة الصناعات التي لم تعد البلاد قادرة على المنافسة فيها بفعالية.
وتخلص القطاع العام من أصول غير فعالة بقيمة مليارات الجنيهات الإسترلينية، وبيعت آلاف الشركات المتأثرة أو سمح لها بالإفلاس، كما سمح التحرير المالي لاقتصاد المملكة المتحدة بالتحول نحو صناعات الخدمات.
وكانت التكلفة التي يتحملها المجتمع واضحة، إذ ارتفعت معدلات البطالة إلى أكثر من الضعف لتقترب من 12%، وتلا ذلك ركود عميق، وهذا ترك ندوبا طويلة الأمد في قلب التصنيع في بريطانيا وخلق انقسامات خطيرة داخل المجتمع.
ولا تزال العواقب باقية ويتردد صداها بعد مرور أكثر من 40 عامًا، وقطعت خطة التحول نحو “رؤية 2030” الخاصة بالسعودية، والتي صيغت بمساعدة جحافل من المستشارين الدوليين وأطلقت في أبريل 2016، شوطًا طويلاً، ووصلت إلى منتصفها الآن، وهذا يعد وقتًا مناسبًا لتقييم ما أنجز وما لم يُنجز بعد.
تعد التحديات التي تواجهها السعودية أكبر بكثير من تلك التي واجهتها مارجريت تاتشر في بريطانيا، وتتعقد هذه التحديات بسبب الرغبة في بناء تحول مستدام ضمن القيود التي يفرضها عالم يتسابق نحو أهداف الحياد الكربوني.
لا تركز السعودية على تقليل اعتمادها الكبير على الصادرات البترولية فحسب، بل تعمل أيضًا على إعادة هيكلة الاقتصاد المحلي المعتمد على طبقات من الإعانات السخية والاحتكارات والمحسوبية، وهذه مهمة ضخمة بدت في البداية غير محتملة ومليئة بالمخاطر.
وفي ظل النظرة الحاسمة للمجتمع الدولي، يحدث هذا التحول في وقت يتواجد فيه تغير المناخ والوقود الأحفوري وتحول الطاقة ضمن دائرة الضوء العالمية.
وهذا التوتر سيبدو واضحًا على الأرجح الشهر المقبل عندما تستضيف الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة السنوي المقبل لتغير المناخ، ورغم أن “رؤية 2030” لا يزال أمامها سبعة أعوام أخرى، إلا أنها حققت بالفعل مجموعة من التأثيرات المثيرة للاهتمام.
أولاً، أدى سحب الإعانات وفرض ضريبة على الاستهلاك إلى تقليص ميزانيات الأسر والشركات في البداية، لكن هذا التأثير تم تعويضه من خلال التوسع المالي والانتعاش الاقتصادي العام.
وانخفضت معدلات البطالة وارتفعت الأجور ونما القطاع غير البترولي في البلاد، وأصبحت التوقعات المالية صحية، رغم تفشي جائحة كورونا وتطبيق واحدة من أشد دورات التشديد النقدي في التاريخ.
ثانيًا، يمكن أن يخلق التغيير الشامل حالة من انعدام اليقين بالنسبة للشركات والأسر، لكن البلاد قدمت دعما واسع النطاق للإصلاح بين الشعب السعودي.
ثالثًا، أصبحت “رؤية 2030” راسخة في الحياة اليومية وأصبحت قضية يبدو أن جيل الشباب حريصون على الانضمام إليها.
رابعًا، أظهر القطاع العام، على نحو غير متوقع، ديناميكية أكبر للقيادة مقارنة بالقطاع الخاص الذي كان تاريخيًا يتجنب المخاطرة.
خامسًا، تُظهر التحركات لبناء مدن مستقبلية في الصحراء، ومكعب استثنائي يبلغ ارتفاعه 400 متر في الرياض، والاستثمارات في الأصول الرياضية ذات المستوى العالمي، رغبة في أن تكون غير تقليدية ومبتكرة.
سادسًا، وربما الأهم، هو أن جميع المؤسسات والهيئات الحكومية وضعت “رؤية 2030” في صميم مهامها، بما فيها صندوق الاستثمارات العامة الذي يبلغ حجمه 700 مليار دولار والذي يضمن ماليًا العديد من البرامج الرئيسية.
لا شيء من هذا يضمن النتيجة بطبيعة الحال، ولابد أن يتحرك المؤشر على العديد من المقاييس الاقتصادية الرئيسية بشكل أكبر بكثير مما حدث حتى الآن، فالاستثمار الأجنبي المباشر متخلف، ولا يزال الاعتماد على الصادرات البترولية مرتفعًا للغاية.
ومع ذلك، ورغم أن التاريخ سيحكم في النهاية على نجاح هذا المشروع، فإنه يزود الاقتصاديين والأكاديميين بالفعل بالأسباب التي تجعلهم ينتبهون إلى هذا النجاح.
في النهاية، هناك أمثلة تاريخية قليلة لاقتصادات مدعومة بصادرات السلع الأساسية تتغلب بفعالية على الاعتماد على الصادرات البترولية، ولهذا السبب يشار إلى هذا الاعتماد في بعض الأحيان باعتباره لعنة الموارد أو مفارقة الوفرة، ولا تزال هناك تحديات كبيرة، لكن هذا يمكن أن يكون العصر الذهبي للخليج، فالتحول الذي تشهده السعودية، حتى لو لم يتحقق بالكامل، سيكون إيجابيًا للغاية بالنسبة للمنطقة وخارجها.