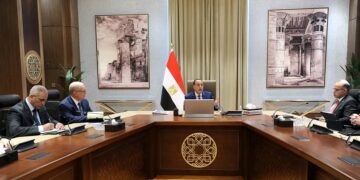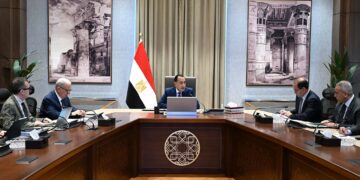وسط جدل متصاعد حول أوضاع الاقتصاد المصري وارتفاع تكلفة الدين المحلي، أثارت مناقشات المنتدى الاقتصادي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة نقاشًا واسعًا حول ما يُعرف بـ«المقايضة الكبرى» بين وزارة المالية والبنك المركزي.
فبينما يرى البعض أنها قد توفر حلًا جزئيًا لإعادة هيكلة الدين وتحسين المؤشرات المالية، يحذر آخرون من مخاطرها، مؤكدين أنها قد تنقل الأزمة من جهة إلى أخرى دون معالجة جذورها الحقيقية، ليظل السؤال: هل هذه الخطوة محاسبية فحسب أم بداية لتخفيف العبء المالي على الدولة والمواطنين؟
هيكل: المقترح المطروح أداة لإعادة ترتيب الدين.. وليس علاجًا جذريًا
قال حسن هيكل، الخبير المصرفي والاقتصادي، إن البنك المركزي المصري يجد نفسه محاصرًا بمجموعة من القيود التي تحد من قدرته على خفض أسعار الفائدة بالوتيرة المطلوبة، في مقدمتها الخوف من موجات دولرة واسعة قد تنتج عن تقليص الفجوة بين العائد على الجنيه والعملات الأجنبية، حتى مع تقارب معدلات التضخم.
وأوضح هيكل، خلال كلمته على هامش المنتدى الاقتصادي لقسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن خفض الفائدة في ظل هذا الوضع قد يدفع المودعين إلى تحويل ودائعهم من الجنيه إلى الدولار أو اليورو، ما يخلق طلبًا إضافيًا على العملة الأجنبية ويضغط على سوق الصرف.
وأضاف أن البنك المركزي لا يمكن أيضًا تجاهل الخلفية الحرجة التي كان يمر بها الاقتصاد قبل صفقة “رأس الحكمة”، مؤكدًا أن من شهد تلك المرحلة الصعبة يصعب مطالبته اليوم بالمغامرة السريعة.
وأشار إلى أنه رغم قناعته بأن خفض الفائدة كان يجب أن يكون أعمق، إلا أن محافظ البنك المركزي يتحمل مسؤولية جسيمة في حال حدوث أي صدمة مفاجئة في السياحة أو تحويلات العاملين، ما يجعل “الكروت المتاحة في يده محدودة مرحليًا”.
وأكد هيكل أن الطرف الذي يدفع الثمن الأكبر لأسعار الفائدة المرتفعة هو الدولة نفسها، باعتبارها أكبر مقترض في الاقتصاد، حيث تقترض بأسعار تتراوح بين 25 و30%.
ولفت إلى أن هذه السياسة أدت في المقابل إلى تضخم غير مسبوق في ربحية البنوك التجارية، نتيجة اتساع الفارق بين سعر الفائدة على الودائع وسعر العائد على أدوات الدين الحكومي.
وأوضح أن البنوك تمنح المودعين عوائد تتراوح بين 13 و14%، بينما توظف هذه الأموال في أذون وسندات خزانة بعوائد تصل إلى 25%، محققة أرباحًا “خالية من المخاطر” تتجاوز 7 و8%، مقارنة بهوامش لا تتجاوز 1% في الأسواق المتقدمة.
واعتبر أن هذا الخلل في هيكل أسعار الفائدة هو السبب الرئيسي وراء القفزات الكبيرة في أرباح البنوك خلال العامين الماضيين.
وفي هذا السياق، طرح هيكل حلًا غير تقليدي يقوم على ما وصفه بـ”المقايضة الكبرى”، تقوم فكرته على تجميع الأصول المملوكة لوزارة المالية – من بنوك وشركات طاقة ونقل وتأمين – في كيان واحد على غرار “صندوق أجيال مصر”، بما يسمح بتقديم ميزانية مجمعة وشفافة لأصول الدولة.
وأوضح أن هذه الأصول، التي تقدر قيمتها بأكثر من 10 تريليونات جنيه، يمكن مقايضتها بجزء مماثل من الدين المحلي المستحق للبنوك التجارية، على أن تنتقل المديونية من وزارة المالية إلى البنك المركزي. وأكد أن هذه العملية لا تعني طباعة نقود جديدة ولا الإضرار بودائع المواطنين، بل تعيد هيكلة العلاقة بين الدولة والجهاز المصرفي.
ودعا هيكل إلى خفض سعر الفائدة إلى 16% خلال الأشهر القليلة المقبلة، بالتوازي مع رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك التي تحقق أرباحًا استثنائية، بما يحقق توازنًا في ميزانية البنك المركزي. كما شدد على ضرورة وقف المشروعات غير الموجهة للتصدير لمدة عام أو عامين، والتركيز على تعظيم الصادرات السلعية.
وقال هيكل، إن جزءًا كبيرًا من الجدل الدائر حول وضع الاقتصاد المصري ناتج عن استخدام تعريفات ومؤشرات غير دقيقة، تستدعي المراجعة قبل أي نقاش جاد حول الحلول، مؤكدًا أن “إعادة تعريف المشكلة هي نصف الطريق نحو حلها”.
وأكد هيكل أن الاقتصاد المصري، وفق المؤشرات الكلية، يمر بأفضل فتراته منذ 15 عامًا، مع نمو حقيقي يتجاوز 5%، واحتياطيات نقدية تتجاوز 50 مليار دولار، وتحسن واضح في السياحة وتحويلات العاملين والصادرات السلعية.
وقال إن الدولة حققت خلال السنوات الماضية فائضًا أوليًا يقارب 3 تريليونات جنيه، ما يعني أن المشكلة ليست في الإنفاق التشغيلي، وإنما في الفوائد المرتفعة على الدين المحلي التي تضاعفت بفعل أسعار الفائدة العالية.
وانتقد هيكل الاعتماد على برنامج بيع الأصول كحل، مؤكدًا أنه غير كافٍ لمواجهة فوائد شهرية تقارب 250 مليار جنيه. وأضاف: “حتى بيع أصول بعشرات المليارات سنويًا لن يغطي سوى جزء محدود من الفوائد، بينما يظل أصل الدين قائمًا ويتضخم”.
أبوالعيون: السياسات المحاسبية لا تعالج أصل الأزمة.. ورفع الاحتياطي الإلزامي يزيد الأعباء
وقال محمود أبوالعيون، محافظ البنك المركزي الأسبق، إن أي نقاش جاد حول السياسات النقدية أو الدين العام يجب أن يبدأ من “المسلمات”، موضحًا أن الدور الأساسي للبنك المركزي، وفقًا للقانون، يتمثل في الحفاظ على استقرار وسلامة النظام النقدي والمصرفي، والعمل على استقرار الأسعار، وهو دور لم يتغير جوهريًا منذ قانون 88 لسنة 2003 وحتى القانون الحالي، باعتباره وظيفة أصيلة لا تخضع لاجتهادات أو تبديل.
وأشار إلى أن القانون منح البنك المركزي صفة المستشار والوكيل المالي للحكومة، وليس ضامنًا لالتزاماتها، لافتًا إلى أن المادة 47 تنظم بوضوح حدود تمويل البنك المركزي لعجز الموازنة الموسمي، بنسبة لا تتجاوز 10% من متوسط الإيرادات العامة، ولمدد قصيرة لا يجوز تدويرها، بما يحافظ على استقلالية البنك المركزي المالية والوظيفية.
وقال إن البنك المركزي يدفع ضرائب ضخمة، إذ تخضع حيازاته من أذون وسندات الخزانة لضريبة تصل إلى 32%، فضلًا عن ضرائب الأرباح التجارية والصناعية التي بلغت في أحد الأعوام نحو 87 مليار جنيه، مشددًا على أن أرباح المركزي تؤول بالكامل إلى الموازنة العامة، بينما تتحمل وزارة المالية خسائره حال حدوثها.
وفيما يتعلق بالاحتياطي النقدي الأجنبي، شدد أبوالعيون على أن المفهوم الصحيح هو صافي الاحتياطي الدولي (NIR)، الذي يعكس النتيجة النهائية لميزان المدفوعات، وليس مجرد رقم اسمي.
وأكد أنه لم يحدث تاريخيًا أن “فقد” البنك المركزي احتياطيه، لكونه مزيجًا من نقد أجنبي وذهب وأصول مالية أجنبية، موضحًا أن الاحتياطي وصل مؤخرًا إلى مستويات قوية، مع تنوع مكوناته.
وأشار إلى أن موارد النقد الأجنبي تشمل إيرادات قناة السويس، والصادرات البترولية، وعوائد الاستثمارات الأجنبية، بينما تتمثل الالتزامات في خدمة الدين الخارجي وتمويل واردات السلع الاستراتيجية، محذرًا من تحميل البنك المركزي أعباء إضافية قد تخل بتوازن هذا الهيكل.
وعن أدوات السياسة النقدية، أوضح أن سعر الفائدة، وعمليات السوق المفتوح، ونسبة الاحتياطي الإلزامي هي الأدوات الأساسية لإدارة السيولة، منتقدًا الطرح القائل برفع الاحتياطي الإلزامي للحد من أرباح البنوك، مؤكدًا أن ذلك يرفع تكلفة الأموال ويُترجم في النهاية إلى زيادة تكلفة الإقراض، دون تحقيق فائدة حقيقية للمركزي.
وفي تقييمه للدين العام، قال إن حجم الدين يمثل تحديًا حقيقيًا لكنه ليس كارثيًا، مستشهدًا بتجارب دول كبرى تتجاوز فيها نسب الدين للناتج المحلي الإجمالي حاجز 100% دون انهيار اقتصادي.
وانتقد أبوالعيون بشدة فكرة “المقايضة الكبرى” أو نقل الديون من وزارة المالية إلى البنك المركزي مقابل أصول، واصفًا إياها بأنها مناقلة محاسبية لا تحل جوهر المشكلة، بل تنقلها من جيب إلى آخر.
وحذر من أن تحميل البنك المركزي بخدمة الدين سيحوّله من دائن للنظام المصرفي إلى مدين له، وهو وضع غير مسبوق ويقوض دوره الرقابي والاستقراري.
وأشار إلى مخاطر الاعتماد على أصول غير مضمونة العائد، مثل إيرادات قناة السويس التي تتأثر بالاضطرابات الجيوسياسية، مؤكدًا أن أي تراجع في العائدات سيضع المركزي في مأزق تمويلي، وقد يعيد إنتاج الخسائر التي تتحملها الموازنة العامة في النهاية.
وطرح أبوالعيون بدائل أكثر واقعية، في مقدمتها رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي من 12% إلى مستويات أقرب للأسواق الناشئة، وتوسيع القاعدة الضريبية، ووضع سقف قانوني للدين العام مرتبط بالناتج المحلي، مع ضبط الإنفاق الجاري غير الضروري.
السمالوطي: صندوق مصر السيادي أكثر كفاءة لإدارة الأصول من تحميل المركزي مسؤوليات مزدوجة
قالت جنات السمالوطي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن جوهر الأزمة الاقتصادية في مصر لا يكمن في تناقض ظاهري بين مؤشرات كلية تبدو إيجابية وبين تدهور أوضاع المواطن، بل في غياب النظرة الشاملة التي تأخذ في الاعتبار عنصر الزمن والاستدامة المالية.
وأضافت السمالوطي أن النقاش الدائر حول ما يُسمى بـ«المقايضة الكبرى» بين وزارة المالية والبنك المركزي قد يحقق تسوية محاسبية آنية، لكنه لا يمثل حلاً حقيقيًا لأزمة الدين، لأن مصر ستظل دولة مدينة سواء كان الدين مُسجلاً على الحكومة أو على البنك المركزي، ما لم يتم التعامل مع الجذور الحقيقية للأزمة.
وأوضحت أن تعقيبها ينطلق من محورين أساسيين؛ الأول يتعلق بالمحاذير والمخاطر المحيطة بالمقترح، والثاني يركز على المسارات الجادة والمستدامة لمواجهة أزمة الدين العام، مشددة على أن دور الاقتصادي هو العودة إلى جذور المشكلة لا الاكتفاء بإدارة أعراضها، حفاظًا على مبدأ أساسي هو الاستدامة المالية للاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أن أزمة الدين في مصر ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج تاريخ طويل يمتد لأكثر من قرن ونصف، منذ أول قرض في عهد سعيد باشا عام 1862، مرورًا بتوسع دور الدولة منذ أواخر الخمسينيات، حيث ترسخ نموذج حكومة ضخمة ذات دور مهيمن في الاقتصاد، دون كفاءة حقيقية أو مردود ملموس على رفاهية المواطنين.
وتساءلت السمالوطي عن أسباب فشل الاقتصاد المصري في تحقيق انطلاقة حقيقية رغم تعدد تجارب التنمية وبرامج الإصلاح، مرجعة ذلك إلى تكرار نفس السياسات والسيناريوهات في غياب رؤية لمشروع تنموي وطني متكامل.
ولفتت إلى أن التجربة الاشتراكية في الستينيات، ثم الاعتماد على الدخول الريعية في السبعينيات والثمانينيات، مثل السياحة وقناة السويس، وصولًا إلى الاكتفاء ببرامج التثبيت والاستقرار المالي في التسعينيات تحت مظلة صندوق النقد الدولي، كلها لم تُترجم إلى إصلاحات هيكلية حقيقية في بنية الاقتصاد الإنتاجي.
وأكدت أن أي مقترح لا يتعامل مع أصل الخلل سيظل مجرد إدارة أزمة مؤقتة، متسائلة عن مبررات تحميل البنك المركزي هذا الدور، في حين أن صندوق مصر السيادي، الذي أُنشئ عام 2018 خصيصًا لإدارة الأصول، يبدو أكثر ملاءمة للتعامل مع هذا الملف، بدلًا من خلط الأدوار بين السياسة المالية والنقدية داخل الدولة.