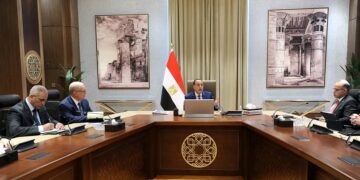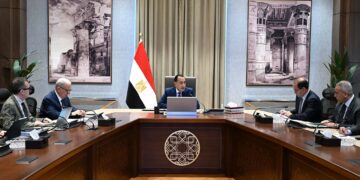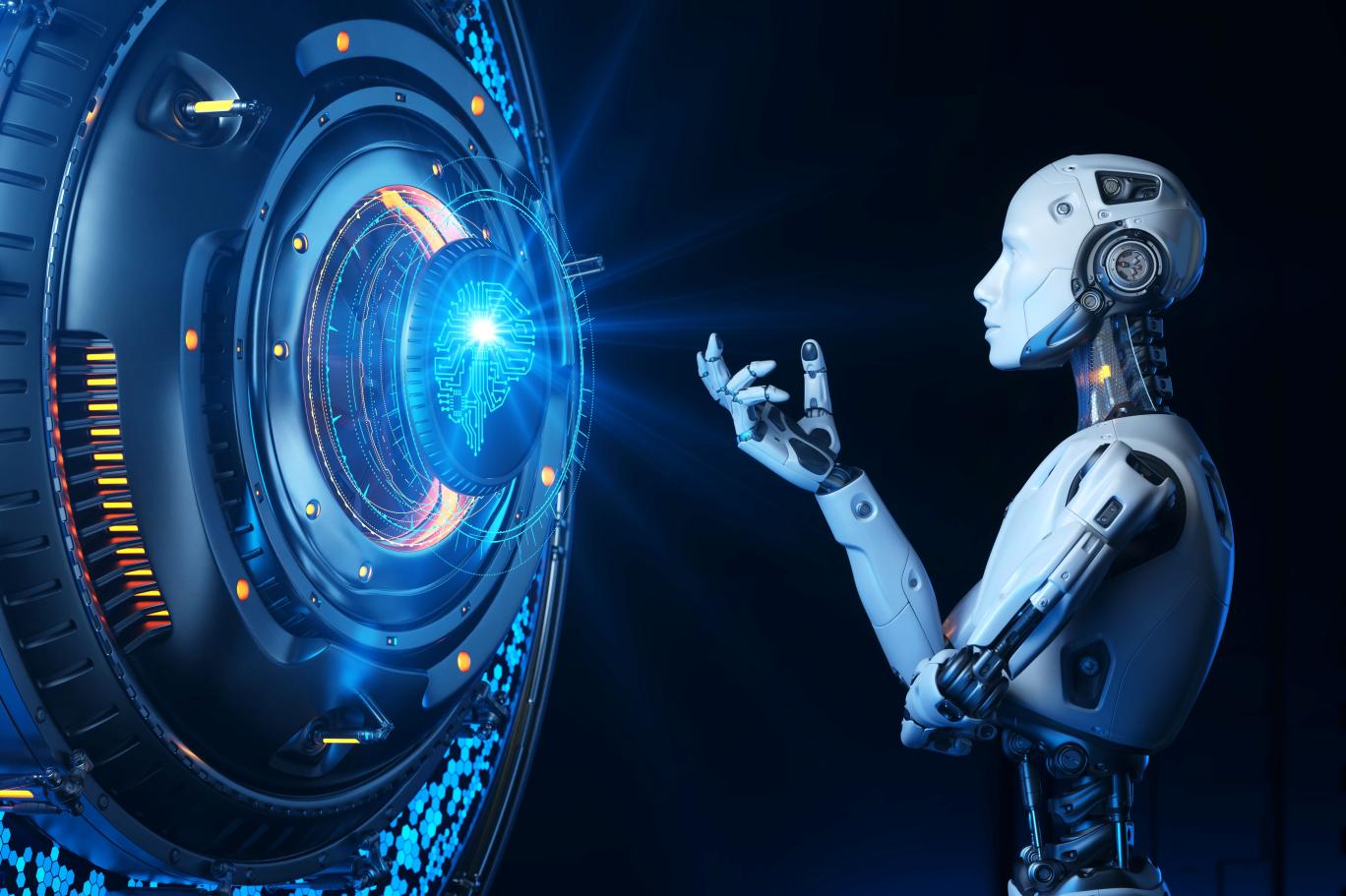تشهد الاقتصادات العالمية تحولًا متسارعًا في طبيعة عوامل القوة والتنافسية، إذ لم تعد التكنولوجيا عنصرًا داعمًا للنمو فحسب، بل أصبحت أحد محدداته الرئيسية.
وفي هذا الإطار، يبرز الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة مؤثرة في صياغة السياسات الاقتصادية، وإدارة الموارد، وتعزيز كفاءة القرار العام، بما يجعله قضية سيادية تتطلب رؤية واضحة على مستوى الدولة.
هذا التحول لا يعكس تطورًا تقنيًا بقدر ما يعكس إعادة تعريف شاملة لمصادر القيمة في الاقتصاد العالمي.
فالدول لم تعد تتنافس فقط على رأس المال أو الموارد الطبيعية، بل على القدرة على تحويل البيانات إلى معرفة، والمعرفة إلى قرارات، والقرارات إلى ميزة تنافسية مستدامة.
وفي قلب هذه المعادلة، يقف الذكاء الاصطناعي كعامل حاسم في تحديد من يملك زمام المبادرة، ومن يظل في موقع التابع.
لم يعد النقاش حول الذكاء الاصطناعي يقتصر على تبني حلولا تقنية أو تحسين كفاءة العمليات، بل امتد ليشمل سؤالًا جوهريًا يتعلق بامتلاك القدرة على توظيفه ضمن إطار يخدم الأولويات الوطنية.
فالفارق الحقيقي اليوم لا يكمن في مدى الاستخدام، وإنما في درجة السيطرة على البيانات، وآليات اتخاذ القرار، والحوكمة المنظمة لتطبيقاته، وهو فارق يحدد بشكل مباشر قدرة الدول على حماية مصالحها الاقتصادية في بيئة عالمية شديدة التنافس.
تعتمد العديد من الدول على حلول جاهزة للذكاء الاصطناعي لتحقيق مكاسب سريعة، إلا أن هذا النهج، رغم جدواه المرحلية، يحمل في طياته مخاطر استراتيجية تتعلق بالاعتماد طويل الأمد، وفقدان المرونة، وتراجع القدرة على توجيه القرار الاقتصادي بشكل مستقل.
فالبيانات، التي تمثل أحد أهم الأصول الاقتصادية المعاصرة، تفقد قيمتها السيادية إذا لم تكن خاضعة لإطار وطني واضح يحكم استخدامها واستثمارها، أو إذا أصبحت مادة خام تُستخرج محليًا وتُعاد معالجتها خارجيًا.
ومن منظور السياسات العامة، يؤثر الذكاء الاصطناعي بصورة مباشرة في ملفات حيوية، في مقدمتها سوق العمل، وإدارة الموارد، وتعظيم الإنتاجية، وتخصيص رأس المال.
كما يلعب دورًا متزايد الأهمية في إعادة تشكيل سلاسل القيمة، حيث تنتقل القيمة المضافة تدريجيًا من مراحل الإنتاج التقليدية إلى مراحل التحليل، والتنبؤ، واتخاذ القرار.
وهو ما يفرض على صناع القرار الانتقال من منطق المبادرات المحدودة إلى تبني استراتيجيات شاملة، تتعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه بنية تحتية وطنية، لا مشروعًا تقنيًا مستقلًا.
وفي هذا السياق، تظهر التكلفة الاقتصادية لعدم الفعل أو تأجيل القرار، فعدم الاستثمار في بناء القدرات التكنولوجية لا يعني الحفاظ على الوضع القائم، بل يؤدي فعليًا إلى تآكل تدريجي في القدرة التنافسية، مع انتقال القيمة المضافة إلى اقتصادات أكثر جاهزية.
هذا النوع من الخسارة لا يظهر فورًا في المؤشرات التقليدية، لكنه يتراكم على المدى المتوسط في صورة تراجع الإنتاجية، وضعف القدرة على الابتكار، وزيادة الاعتماد على الخارج في أدوات اتخاذ القرار.
وتبرز هذه التكلفة بشكل خاص في القطاعات ذات الكثافة المعرفية العالية، إذ أصبحت الخوارزميات والنماذج التحليلية جزءًا أساسيًا من تسعير المخاطر، وتخصيص الموارد، وتحديد اتجاهات السوق.
الاقتصادات التي لا تمتلك هذه الأدوات تجد نفسها مضطرة لاستيراد القرار، لا التكنولوجيا فقط، وهو ما يحد من قدرتها على الاستجابة السريعة للتغيرات، ويجعلها أكثر عرضة للصدمات الخارجية.
كما أن تأخر بناء القدرات يخلق فجوة يصعب سدّها لاحقًا، إذ تتطلب صناعة الذكاء الاصطناعي تراكمًا معرفيًا واستثماريًا طويل الأجل. وكلما طال التأجيل، ارتفعت كلفة الدخول، ليس فقط ماليًا، بل مؤسسيًا وبشريًا، وهو ما يضعف قدرة الاقتصادات الناشئة على اللحاق بالموجة في مراحلها المتقدمة.
وفي الوقت نفسه، يتغير موقع الدول داخل سلاسل القيمة العالمية، فلم يعد هذا الموقع يتحدد بقدرتها على الإنتاج فقط، بل بقدرتها على التحكم في مراحل التحليل، والتنبؤ، واتخاذ القرار.
وفي الاقتصاد الرقمي، تنتقل القيمة تدريجيًا من التصنيع والتنفيذ إلى التصميم، والنمذجة، والتحليل المتقدم، وهي مجالات يرتكز معظمها على الذكاء الاصطناعي.
الدول التي تستثمر في بناء هذه القدرات تنتقل من موقع المورد أو المنفذ إلى موقع الشريك في صناعة القيمة، بينما تظل الدول التي تكتفي بالاستخدام في موقع المستهلك النهائي.
هذا التحول لا ينعكس فقط على الميزان التجاري، بل على قدرة الدولة على جذب الاستثمارات النوعية، وبناء صناعات عالية القيمة، وتعزيز مرونة اقتصادها في مواجهة التحولات العالمية.
وفي هذا الإطار، لا يمكن فصل الذكاء الاصطناعي عن الرؤية الاقتصادية طويلة الأجل للدولة. فبناء القدرة التكنولوجية ليس قرارًا آنيًا، بل مسارًا تراكميًا يتطلب استمرارية في السياسات، ووضوحًا في الأولويات، وقدرة على التنسيق بين الجهات المختلفة.
الدول التي تنجح في هذا المسار هي تلك التي تتعامل مع الذكاء الاصطناعي كجزء من نموذجها التنموي، لا كمبادرة منفصلة أو استجابة ظرفية لضغوط السوق أو التحولات العالمية.
كما أن غياب هذا الاتساق يؤدي غالبًا إلى تشتيت الجهود بين مبادرات متفرقة، تفتقر إلى التأثير الحقيقي، رغم كلفتها المرتفعة.
ودون رؤية واضحة تربط بين التعليم، والبحث العلمي، والاستثمار، والتنظيم، تتحول مشاريع الذكاء الاصطناعي إلى جزر منعزله، عاجزة عن إنتاج قيمة اقتصادية مستدامة.
ومن هنا، تبرز أهمية الانتقال من إدارة التكنولوجيا إلى قيادة التحول التكنولوجي ضمن إطار وطني متكامل.
وتزداد أهمية هذا التحول في الاقتصادات الناشئة، إذ تمثل البيانات المتولدة من القطاعات الاقتصادية المختلفة فرصة حقيقية لبناء نماذج محلية قادرة على دعم النمو ورفع الكفاءة.
فالأسواق الواسعة، وتنوع الأنشطة الاقتصادية، وتراكم البيانات التشغيلية، تشكل جميعها أساسًا مناسبًا لبناء قدرات تنافسية حقيقية.
غير أن تحقيق ذلك يتطلب استثمارات متوازنة في البنية التحتية الرقمية، وبناء القدرات البشرية، ووضع أطر تنظيمية تضمن الاستخدام المسؤول والمستدام للتكنولوجيا.
وفي هذا السياق، يلاحظ تنامٍ في اهتمام مؤسسات الدولة بملف الذكاء الاصطناعي، تجلّى في إطلاق استراتيجيات وطنية، ومحاولات تشريعية وتنظيمية تهدف إلى مواكبة التحولات المتسارعة في هذا المجال.
وتمثل هذه الجهود خطوة مهمة نحو بناء إطار حاكم للتكنولوجيا، يوازن بين تشجيع الابتكار وحماية الاستقرار، إلا أن تعظيم أثرها الاقتصادي يظل مرهونًا بالقدرة على الانتقال من دعم الاستخدام إلى تحفيز صناعة التكنولوجيا وبناء القدرات المحلية بصورة مستدامة.
كما تبرز الحاجة إلى حوكمة واضحة تحدد المسؤوليات، وتضع ضوابط لاستخدام الذكاء الاصطناعي في القرارات المؤثرة في الأفراد والأسواق، بما يحفظ التوازن بين الابتكار والاستقرار.
فغياب هذا الإطار لا يؤدي فقط إلى مخاطر تنظيمية، بل يخلق أيضًا تكلفة اقتصادية غير مباشرة، تتمثل في ضعف الثقة، وارتفاع درجة عدم اليقين، وتراجع جاذبية الاستثمار طويل الأجل.
وإذا كان الذكاء الاصطناعي قرارًا سياديًا، فإن التمويل يمثل أداته التنفيذية، فبناء القدرات التكنولوجية لا يتحقق بالخطابات أو المبادرات الرمزية، وإنما بتوجيه رأس المال نحو الشركات التي تطور التكنولوجيا، لا تلك التي تكتفي باستخدامها.
فالفرق بين المسارين هو الفرق بين الاستثمار في أصل استراتيجي طويل الأجل، والاعتماد على حلول مؤقتة ذات أثر محدود.
وعلى مستوى الاستثمار، يبرز دور المستثمرين في التمييز بين نماذج أعمال قائمة على استهلاك أدوات جاهزة، وأخرى تعمل على بناء قدرات حقيقية في البيانات، والنماذج، والبنية التحتية.
ودعم الفئة الثانية لا يمثل فقط فرصة لتحقيق عائد أعلى على المدى الطويل، بل يسهم مباشرة في بناء قاعدة اقتصادية أكثر استقلالًا، ويعزز قدرة السوق المحلية على توليد قيمة مضافة حقيقية.
أما على مستوى السياسات العامة، فإن تشجيع صناعة التكنولوجيا يتطلب إعادة توجيه أدوات التمويل، وفي مقدمتها الصناديق الاستثمارية، نحو الشركات العاملة في مجالات البحث والتطوير، وبناء النماذج، وتوطين المعرفة، بدلًا من الاكتفاء بتمويل تطبيقات الاستخدام النهائي.
فالدول التي نجحت في بناء قدرات تكنولوجية مستدامة، لم تفعل ذلك عبر الاستهلاك، بل عبر تحمّل كلفة الاستثمار طويل الأجل في المعرفة والبنية التحتية.
ولا يمكن للدولة الساعية إلى تعزيز سيادتها الاقتصادية أن تعتمد فقط على استيراد الحلول، بل تحتاج إلى منظومة تمويلية تشجع المخاطرة المحسوبة في بناء التكنولوجيا، وتمنح الشركات المحلية مساحة للنمو والتجربة والتطور.
وددون هذا الدعم، تظل الابتكارات محصورة في نطاق الاستخدام، لا الصناعة، وتبقى القيمة الحقيقية خارج حدود الاقتصاد المحلي.
وفي هذا السياق، لا يتعلق التحدي الحقيقي بسرعة تبني الذكاء الاصطناعي بقدر ما يتعلق بجودة الاختيارات المرتبطة به.
فالتكنولوجيا في حد ذاتها محايدة، لكن نتائجها الاقتصادية تتحدد وفق الإطار الذي تُستخدم داخله، والجهة التي تملك قرار توجيهها.
الدول التي تضع الذكاء الاصطناعي ضمن رؤية تنموية واضحة، وتربطه بأهداف الإنتاج والتنافسية وبناء المعرفة، تكون أكثر قدرة على تعظيم العائد منه.
أما الدول التي تتعامل معه كحل سريع أو استجابة ظرفية، فتظل عوائدها محدودة، مهما توسّع نطاق الاستخدام.
وفي نهاية المطاف، فإن توجيه الاستثمار نحو صناعة الذكاء الاصطناعي، لا مجرد استهلاكه، هو ما يحدد موقع الدول في خريطة الاقتصاد العالمي الجديدة.
إما أن نكون شركاء في صناعة التكنولوجيا،أو نظل مستخدمين لقرارات تُصاغ خارج حدودنا.