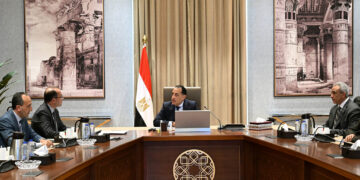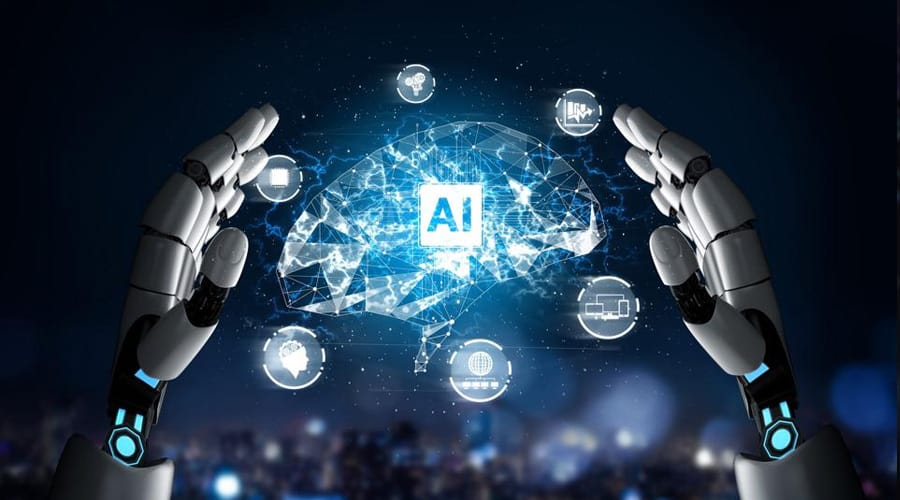بلغ فائض الصين التجاري تريليون دولار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى فقط من عام 2025، وهو رقم ضخم ينبغي أن يدق ناقوس الخطر في بكين كما في بقية عواصم العالم. فهذا الفائض الهائل يعكس بلا شك القوة التنافسية اللافتة للصادرات الصينية، لكنه في الوقت نفسه يكشف اختلالات عميقة في بنية الاقتصاد الصيني وفي السياسات التي تنتهجها الحكومة. كما أنه يقوض مساعي بكين لتقديم نفسها حامياً لنظام التجارة العالمي القائم على القواعد، ويضعف طموحها في تعزيز الدور الدولي لعملتها.
لقد بات نموذج النمو الصيني أكثر هشاشة وصعوبة في الاستمرار. فمنذ جائحة كوفيد، واصل الاقتصاد الاعتماد على الوصفة القديمة القائمة على الاستثمار الممول بالائتمان للحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي، رغم تقلص القوة العاملة وضعف الإنتاجية. وفي المقابل، أدى تباطؤ نمو الوظائف والأجور، مع تراجع أسعار العقارات وتآكل الثقة في الحكومة، إلى كبح الاستهلاك المحلي. ونتيجة لذلك، اتسعت الفجوة بين إنتاج المصانع والطلب الداخلي، ولم يبقَ أمام الصين سوى التصدير متنفساً وحيداً.
غير أن هذا الاندفاع التصديري يحمل تبعات سلبية على الاقتصاد العالمي. فبدلاً من أن تكون الصين محركاً لنمو الطلب الاستهلاكي العالمي، أصبحت عبئاً عليه. كما أن المستويات المرتفعة من الاستثمار — التي تتحمل العبء الأكبر منها الشركات المملوكة للدولة — لم تترجم إلى مكاسب ملموسة في الإنتاجية أو تحسن في ربحية الشركات. وزادت إجراءات الحكومة لكبح الشركات الخاصة سريعة النمو، إلى جانب تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، من تآكل ثقة قطاع الأعمال وأضعفت الاستثمار الخاص.
وتبدو القيادة الصينية مطمئنة على وضع الاقتصاد، لا سيما مع توقع تسجيل نمو يقترب من 5 في المئة هذا العام. ولا شك أن الحكومة تدرك الحاجة إلى إعادة توازن النمو عبر تعزيز الاستهلاك الأسري ورفع الإنتاجية. غير أن هذه القناعة لا يرافقها إحساس حقيقي بالإلحاح، ولا جدول زمني واضح لإجراءات ملموسة تحقق تلك الأهداف. وبدلاً من ذلك، تلوّح بكين باستخدام أدوات التحفيز الكلي لمواجهة أي تباطؤ محتمل، في محاولة جديدة لمعالجة مشكلات هي في الأساس نتاج تدخلات مركزية سابقة.
وتندرج سياسة «مكافحة الانغماس المفرط في المنافسة» (anti-involution) ضمن هذا النهج، إذ تهدف إلى كبح المنافسة الشرسة التي أدت إلى ضغوط انكماشية وتراجع أرباح الشركات. إلا أن هذه السياسة لا تبعث برسائل مطمئنة للقطاع الخاص، بل ساهمت في توقف مفاجئ للاستثمار. كما أن خفض أسعار الفائدة وتيسير الائتمان لن يكون لهما أثر يُذكر في مناخ تسوده الشكوك.
إن طريق إعادة التوازن الاقتصادي معروف وواضح. فهو يمر عبر إصلاحات في أسواق العمل، والنظام المالي، والعلاقات المالية بين الحكومة المركزية والأقاليم، إلى جانب تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتمكين القطاع الخاص. ويُعد قطاع الخدمات محورياً في هذا السياق، إذ يمتلك القدرة على خلق فرص عمل أفضل والمساهمة في معالجة ضعف الاستهلاك.
لكن بدلاً من ذلك، عوّضت الصين الرسوم الجمركية المرتفعة على صادراتها إلى الولايات المتحدة بزيادة كبيرة في صادراتها إلى أسواق أخرى. والمشكلة أن معظم هذه الدول تعاني أصلاً من ضعف صناعاتها التحويلية وركود الطلب المحلي، ما يجعلها تعتمد بدورها على التصدير لتحقيق النمو. ومن الطبيعي، في ظل هذا الواقع، أن تلجأ دول كثيرة إلى إقامة حواجز حمائية في مواجهة سيل الصادرات الصينية.
ويبدو دفاع بكين الصارم عن قواعد التجارة العالمية فاقداً للمصداقية حين تستخدم تلك القواعد لتحقيق أهداف قصيرة الأجل على حساب فرص نمو الدول الأخرى. كما أن الزعم بأن تنافسية الشركات الصينية نتاج قوى السوق وحدها يتجاهل حجم الدعم الحكومي للمصنّعين والقيود المفروضة على دخول الشركات الأجنبية إلى السوق الصينية. وإلى ذلك، استخدمت الصين سعر صرف الرنمينبي أداة لتعزيز الصادرات، إذ تراجعت قيمة العملة، على أساس تجاري مرجّح، خلال العام الماضي. ومن غير المنطقي أن تنخفض عملة دولة تتمتع بفائض تجاري ضخم ومستمر لو تُرك سعر الصرف لقوى السوق.
وينبغي للبنك المركزي الصيني أن يلتزم فعلياً بتعهده السماح للرنمينبي بالتحرك بحرية أكبر. فأي ارتفاع ناتج في قيمة العملة من شأنه أن يخفف العبء الذي تمثله الصين على نمو الاقتصاد العالمي، وأن يعزز فرص الرنمينبي في اكتساب مكانة أوسع في النظام المالي الدولي، بشرط ألا يُنظر إليه كعملة خاضعة لإدارة صارمة.
وخلاصة القول، إن تركيز الصين على أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي المدفوعة بالصادرات لم يعد كافياً ولا مستداماً. فالإصلاح الاقتصادي الحقيقي وكبح الفوائض التجارية لم يعودا ضرورة للعالم فحسب، بل مصلحة مباشرة للصين نفسها.